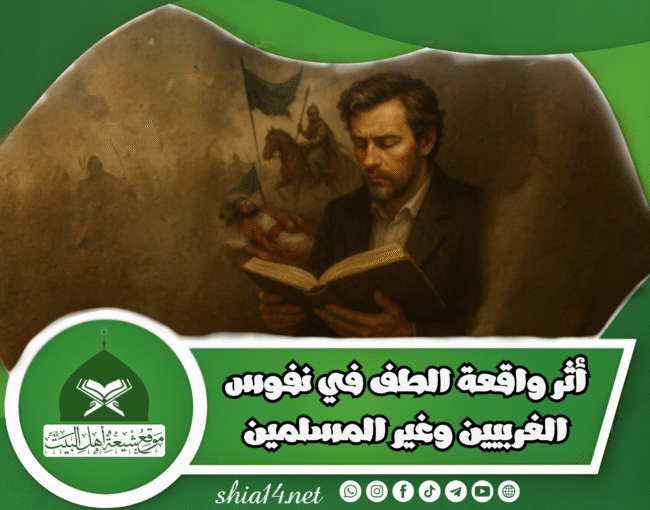كربلاء كما رآها الغرب: حين تصرخ الشهادة في وجه الصمت
مدخل: صوت من أرض كربلاء يهزّ ضمير العالم
في عالمٍ تتصارع فيه المصالح وتُطمس فيه المبادئ، تُطلّ واقعة كربلاء من عمق التاريخ الإسلامي، لا كحرب، بل كـمرآة أخلاقية كونية لا تزال تُثير في النفوس رهبة التساؤل: كيف يمكن لإنسان أن يختار الموت وهو يعلم أنه ذاهب إليه؟
هذا ما فعله الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)، حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وآله)، حين واجه بأهله وأصحابه جيشًا جرارًا يزيد على ثلاثين ألفًا، لا لينتصر، بل ليُعلن أنّ الحق لا يُقاس بعدد الجنود، بل بقيمة الموقف.
رغم أنّ الحسين (عليه السلام) شخصية مركزية في التاريخ الشيعي، إلا أنّ صداه تجاوز الأديان والحدود والثقافات، فوجدت كربلاء صداها في أقلام المؤرخين، والفلاسفة، والمستشرقين غير المسلمين، الذين رأوا فيها ملحمةً تتفوق على التراجيديات الإغريقية، وأسطورةً واقعية تفيض بالكرامة الإنسانية.
الحسين (عليه السلام) في عيون المؤرخين الغربيين: نبض الضمير في التاريخ
قال المؤرخ البريطاني الكبير إدوارد جيبون، صاحب مؤلف تاريخ انحدار وسقوط الإمبراطورية الرومانية، في وصفه لكربلاء: “في زمن ومكان بعيدين، ستوقظ مأساة الحسين تعاطف أبرد القرّاء”.
أما الفيلسوف الاسكتلندي توماس كارلايل، فاعتبر الحسين مدرسة في البطولة الأخلاقية، وكتب: “أفضل دروس البطولة يمكن تعلمها من الحسين (عليه السلام). لقد قاد قلة واجهت كثرة، لا طمعًا في دنيا، بل دفاعًا عن العدالة.”
وأضاف: “الحسين لم يُهزم، بل انتصر بروحه، إذ خاض معركة لا في ساحة حرب بل في وجدان الإنسانية”.
ولم يكن رابندراناث طاغور، الأديب الهندي الحائز على نوبل، أقل انبهارًا، إذ قال: “إذا أردتُ أن أكون إنسانًا حرًا، فعليّ أن أكون مثل الحسين.”
رؤية الفلاسفة: حين يتحوّل الدم إلى فكرة خالدة
أما الفيلسوف الألماني غوته، فحين تأمل قصة كربلاء، لم يرَ فيها صراعًا بين شخصين، بل بين الحقيقة والباطل، وعلّق في إحدى تأملاته: “الحسين هو المبدأ الثابت في وجه التنازل… وصوته الحزين في صحراء كربلاء يعلّمنا كيف نحيا أحرارًا ونموت أعزاء.”
المستشرق البريطاني أربيري رأى كربلاء كتراجيديا كبرى، وكتب: “كربلاء ليست حادثة دينية عابرة، بل تراجيديا إنسانية مكتملة الأركان، بطلها يعرف المصير، ومع ذلك لا يتراجع.”
والمفكر الفرنسي أنطوان بارا، في كتابه الحسين في الفكر المسيحي، قال عبارته الخالدة: “لو كان الحسين منا، لجعلنا له من كل أرضٍ صليبًا، ورفعناه فوق كل راية، وكتبنا عنه إنجيلاً جديدًا.”
في كربلاء لا يُبكى الموت بل تُستنهض الحياة
في زيارتها للعراق، رصدت المستشرقة والرحّالة فريا ستارك طقوس عاشوراء، ووصفتها لا كمشهد ديني مغلق، بل كـطقس ولادة للذاكرة الجماعية، وقالت: “في هذه الطقوس لا يُستعاد الماضي، بل يُخلقُ معنى جديد للحاضر، حيث يتحول الحزن إلى يقظة، والدموع إلى قسم أخلاقي”.
المؤرخ الأمريكي مارشال هودجسون، في موسوعته The Venture of Islam، رأى أنّ كربلاء كوّنت لدى الشيعة هوية مقاومة روحية، حيث الألم ليس عجزًا، بل طاقة تُمجّد المبدأ وتُنقذ الكرامة من الانهيار.
أما الكاتبة ليزلي هازلتون، صاحبة كتاب بعد النبي، فقد كتبت بإعجاب: “ثورة الحسين لم تكن ثورة سياسية، بل صرخة في وجه الانهيار الأخلاقي… كان يعلم أنه ذاهب إلى الموت، لكنه مضى ليكشف الحق أمام العالم.”
كربلاء في ضمير الثوار: مدرسة اللاعنف والشرف
قال المهاتما غاندي، حين سُئل عن مصدر إلهامه: “تعلمت من الحسين كيف أكون مظلومًا فأنتصر.”
لقد استلهم غاندي من الحسين (عليه السلام) معنى المقاومة غير العنيفة، ومعنى أن المبدأ هو السلاح الذي لا يهزمه الحديد.
أما المناضل الأمريكي ويليام لوثر فكتب: “ما فعله الحسين في كربلاء هو درس للبشرية كلّها: لا تُقاس الثورات بنتيجتها السياسية، بل بصدقها الروحي.”
مأساة أم رسالة؟ الحسين في عيون فلاسفة الغرب
كتب المفكر الإيطالي لويجي فيرينو: “قليلون في التاريخ يعرفون أن الموت قادم إليهم، ويمضون إليه بأعين مفتوحة. الحسين هو أحد هؤلاء القلة.”
وقال الباحث المسيحي شارل برنارد: “الحسين والمسيح يجتمعان في المعنى؛ كلاهما رفضا التنازل، وقَبِلا الألم من أجل الحقيقة.”
الخاتمة: الحسين أبديًّا في ضمير العالم
في نظر هؤلاء المفكرين والمستشرقين، كربلاء ليست مجرد حادثة شيعية، بل هي صرخة ضد الظلم، ونشيد أخلاقي خالد، ومدرسة إنسانية تُعلّمنا أن الهزيمة ليست في السقوط، بل في الصمت أمام الطغيان.
ولعل أبلغ ما يُقال هو ما اختصره الإمام الحسين (عليه السلام) بنفسه حين قال: “إنّي لم أخرج أشرًا ولا بطرًا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدّي.”
وهكذا، بقيت كربلاء، وبقي الحسين (عليه السلام)، لا فقط في مآتم العاشقين، بل في وجدان كل من يبحث عن الحق، والحرية.